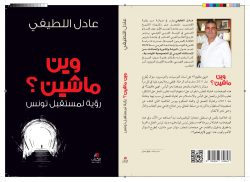إذا بدأنا بأصل الحدث المؤسس للوضع الجديد سنة 2011، أي الثورة، نقول إنه من البديهي ألا يتطابق التحليل المعرفي مع نظرة الفاعلين الاجتماعيين. فالرؤية العلمية تبقى محكومة بهاجس البحث الموضوعي في ظاهرة مركبة، في حين يبقى الفاعل الاجتماعي رهن ذاتيته في إطار هواجس الواقع اليومي وانتظاراته. ومن الطبيعي أن يربط هذا الفاعل كل انتكاسات واقعه بالحدث المؤسس للمرحلة الجديدة. بل ذهب البعض أبعد من ذلك باعتبار الثورة عملا خارجيا تم التدبير له من أجل ضرب الدولة. لكن علينا أن نعي بأن الثورة لم تكن ضد الدولة الوطنية، بل على العكس من ذلك تدخل ضمن مسار تطوّرها منذ تأسيسها بعد الاستقلال إلى اليوم. فكما أنّ الثورة مؤشر على تطوّر الدولة (بمعناها الشامل كتنظيم une organisation)، فإن عراقة تقاليد الدولة هي التي منعت تحول الثورة إلى مظاهر عنف شامل كما شهدته بلدان عربية أخرى. إنّ ما شهدته تونس بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 يدخل ضمن التطور “الطبيعي” للدولة الوطنية التونسية بالانتقال من الحكم الأحادي نحو التشاركية السياسية من أجل ضمان الحقوق. كما ينخرط في إطار أشمل هو تطوّر كل شعوب العالم باتجاه الحريات لأنها تمثل أساس تقدم الشعوب. نقول ذلك كي نخرج من عقلية المؤامرة التي صاحبت الفكر العربي عموما منذ دخوله عصر الحداثة والتي تعكس عجزا على مواجهة الذات وتناقضاتها مما أغرق هذا الفكر في المحافظة وفي الماضويات وفي المشاريع الاستعادية.

كما نرى من خلال الرسم البياني (من كتاب “الدولة والثورة والحداثة”)، تدخل بعض الثورات ضمن الانتقال من الدولة التقليدية نحو الدولة الحديثة، مثل الثورة الفرنسية 1789 والثورة الروسية 1917 والثورة الصينية 1949. وهي تمثل التحول من نمط الدولة والمجتمع الفلاحيين التقليديين نحو نمط الدولة الوطنية الحديثة حيث يتفوَّق عالم المدينة. إنه نموذج الثورات الاجتماعية. وهي ثورات قليلة في التاريخ الحديث والمعاصر، لكنها شاملة وتؤدي عادة إلى تغيير جذري وسريع لهياكل الدولة والطبقات الاجتماعية كما تكون عادة نتيجة صراع طويل بين الطبقات. هذا ما شهدته فرنسا بعد ثورتها من خلال تراجع طبقة الأرستقراطية لصالح الطبقة الثالثة من البرجوازية وأصحاب المهن الحرة والشرائح الشعبية الطامحة إلى العدالة. وهذا ما حصل أيضا في الحالة الروسية بعد ثورات 1905 و1917 بتراجع الأرستقراطية الزراعية لصالح طبقة العمال والمزارعين كما حصل في الحالة الصينية سنة 1949. أما على المستوى السياسي فقد أفرزت هذه الثورات تحولا هيكليا بالانتقال من الدولة السلالية، أي الدولة التقليدية، نحو الدولة الوطنية. فالثورة الاجتماعية في النهاية ثورة ضد نمط من الدولة من أجل نمط آخر ومن الصعب مقارنتها بالثورات السياسية.
أما الثورة السياسية، فمرتبطة بالانتقال، ضمن نفس إطار الدولة الوطنية، من نظام احتكار التمثيل، أو التمثيل الأحادي في إطار تسلطي، حسب الوضعيات، نحو النظام التعددي. لكن بالرغم من أنها ثورات سياسية، فعادة ما تتم على خلفية اجتماعية مثل التهميش الاجتماعي وهنا يأتي التلازم بين البعد الاجتماعي، أي بين العدالة الاجتماعية ومستوى العيش أو جودة الحياة ومسألة الحريات. وقد كان ذلك بارزا في الثورة التونسية. فالمطالبة بالحقوق الاجتماعية تستوجب فرض المشاركة المواطنية في الفضاء العمومي الذي كان محتكرا من طرف الحكم الأحادي. لذلك عادة ما يكون سياق ما بعد الثورة السياسية ليبراليا بامتياز. فعلى المستوى السياسي يتمّ تركيز الشروط المؤسساتية والقانونية للتعددية السياسية من أجل ضمان الحقوق. أما على المستوى الاقتصادي فتكون استعادة القدرة الإنتاجية للإقتصاد من أهم الرهانات في انتظار مراجعة نموذج التنمية القديم. وتدخل في هذا الإطار ثورات ربيع الشعوب في أوروبا سنة 1848 والثورة البرتغالية سنة 1974 والثورة الإيرانية سنة 1979 رغم تحولها إلى ثورة ذات صبغة دينية، وكذلك الثورة التونسية سنة 2011.
والثورات في التاريخ هي مجرد لحظات قطع مع السلطة تمثل فرصة للبناء، تدخلها المجتمعات والدول بحسب إمكاناتها لتعطيها وجهة ما. إنّ تغلغل الإسلام السياسي الشيعي في المجتمع الإيراني، هو ما أفرز المنحى الديني الشمولي سنة 1979 وليست الثورة. كذلك في تونس، بيّن واقع ما بعد الثورة قوّة الإسلام السياسي من حيث امتداده المجتمعي بالرغم من تقاليد التحديث التونسي. وكما في الحالة الإيرانية، لعب معطى الإسلام السياسي، باعتباره يمثل ثقافة من بين ثقافات ما قبل الدولة، دورا بارزا في تحويل وجهة الانتقال السياسي والمجتمعي في تونس بعد 14 جانفي وفي محاولات الِردّة إلى ما قبل الدولة. كيف ذلك؟
تبقى السياسة، من حيث مادتها الأساسية ومن حيث المنطق العام الذي يحكمها، على ارتباط وثيق بمراحل تطور الدولة-الأمة أي الأمة السياسية. ففي كل مرحلة تدور السياسة حول إشكالية عامة كبرى ولكل مرحلة منطقها الخاص الذي يحكم العملية السياسية ورهاناتها. وتتوالى المراحل حسب تراكم التجربة سياسيا (قوانين ومؤسسات وفاعلين) ومجتمعيا (مدى الانخراط المجتمعي واستيعاب التحولات من طرف المواطن). في مرحلة التأسيس، كما في تونس مباشرة بعد الاستقلال أو كما في زمن نابليون في فرنسا أو زمن كمال أتاتورك في تركيا، عادة ما تكون الدولة هي المادة الأساسية للسياسة، والمنطق الذي يحكمها هو فرض التجانس. إذ تتمحور السياسة في مرحلة التأسيس الوطني حول الدولة وما هو ضد الدولة مثل الثقافات التقليدية العشائرية، والطائفية والجهوية والدينية. ضمن هذا المنطق حاول بورقيبة مثلا تحييد كل هذه الثقافات إلى حدود بداية السبعينات. أما المنطق الذي حكم هذه السياسة فهو فرض التجانس حول الدولة وحول الهوية الوطنية الجديدة حتى عن طريق استعمال الإكراه الأقصى، أي قوة الدولة. لذلك لا تصاحب هذه الفترات التأسيسية عملية ديمقراطية في أغلب البلدان. وتكمن أهميّة هذه المرحلة في بناء الإطار المشترك وهو الدولة الوطنية بهويتها وإدارتها ونخبتها.
في مرحلة ثانية وفي سياق مسار تطور الدولة تتشكل النخب والتشكيلات الوسيطة المختلفة، أحزابا ومنظمات وجمعيات. خلال هذه المرحلة يصبح موضوع السياسة هو الحكم وذلك في مستويين: المستوى الأول هو مستوى شرعية الحكم الأحادي، سواء أكان فردا أو حزبا أو مجموعة ما. ثم المستوى الثاني هو مستوى التمثيلية أو التشاركية السياسية. فموضوع الحكم هنا يدخل في إطار المطلبية الديمقراطية. وهذا ما عاشته تونس تقريبا منذ بداية السبعينات إلى انتخابات سنة 1981 وإلى 7 نوفمبر 1987 ثم إلى الثورة. كل هذا يدخل، من وجهة نظر تاريخية، في مسار المطلبية الديمقراطية وفي إطار تطور الدولة.
أمّا في المرحلة الديمقراطية (انتقال أو استقرار ديمقراطي) فمن المفروض أن تتراجع إشكالية هوية الدولة وحيادية أجهزتها لأنه تم حسمها خلال مرحلة التأسيس وما بعده وتَشكَّل حولها إجماع. كذلك لم تعد إشكالية الحكم مطروحة بحكم التداول الديمقراطي على السلطة. بالتالي، وعلى عكس مرحلة بناء الدولة الوطنية، يكون الموضوع الأساسي للسياسة في المراحل الديمقراطية هو تسيير الشأن العام (اقتصاد، خدمات…) والتحديث المؤسساتي والمجتمعي وخاصة ضمان العدالة الاجتماعية وما يصاحبها من جودة الحياة. فهذا المعطى الأخير حاضر بقوّة في أغلب الدول العريقة في الديمقراطية بتعبيرات مختلفة. وهذا يعني، من وجهة نظر تاريخية إلى حدّ الآن، أنّ العدالة الاجتماعية، باعتبارها منظومة من الحقوق، لا يمكن أن تبرز سواء كموضوع للنقاش أو كمطلب إلا في ظل الحرية. أي أنّ الحريات، أو الحريات السياسية بالأساس، هي التي تفتح الباب للحقوق بما فيها العدالة الاجتماعية وجودة الحياة. لذلك تتطور كل الدول نحو التمثيلية (la représentativité) الديمقراطية ونحو الحريات في إطار يشبه الحتمية التاريخية والسؤال هو حول الثمن الذي ستدفعه تلك الدولة أو ذلك الشعب نتيجة تأخّر تركيز منظومة الحريات والحقوق في إطار ديمقراطي. لكن هذه الحتمية لا تنفي مخاطر التراجع الديمقراطي وهي معروفة وحصلت في بلدان ذات عراقة في هذا التقليد. أمّا المنطق الذي يحكم السياسة في المرحلة الديمقراطية فهو منطق التصرف في الاختلافات عن طريق الانتخابات المعبرة عن الخيارات الشعبية وعن الشرعية. وهذا في الحقيقة ما بدأ العمل عليه طوال سنة 2011 في إطار تشاركية بين الدولة وبين القوى المجتمعية ممثلة في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. وهو ما لاحظناه أيضا من خلال تواصل الإدارة مباشرة بعد الثورة وتوجهها ولو باحتشام نحو عدم التسييس (dépolitisation). فقد كان العنوان الأبرز لسنة 2011 هو الانتقال السلمي للسلطة بفضل احتضان الدولة للثورة وبداية العمل على وضع الأسس الضامنة للانتقال الديمقراطي. لكن للأسف، مثَّل صعود قوى سياسية تتعارض في طبيعتها مع مسار تطوّر الدولة، ضربة لهذا التطور التاريخي، مما أدخل البلاد في حالة من عدم التأقلم الهيكلي بين متطلبات المرحلة تاريخيا (الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وجودة الحياة ومعالجة القلق الاجتماعي) وطبيعة الفاعلين وممارسة الحكم.