تعيش بلادنا منذ انتخابات أكتوبر 2011 ما يشبه التيه السياسي؛ يشهد عليه تعدد الحكومات وتشتت الأحزاب وقصر عمرها وتذبذب نتائجها من انتخابات إلى أخرى، وصولا إلى سياق معاكس يضرب الأحزاب والانتخابات والسياسة باعتبارها شأنا عاما. وقد دفعت السياسات العمومية الثمن الأبرز لهذا التيه من خلال تراجع الاقتصاد وتدهور الوضعية الاجتماعية نتيجة البطالة والارتفاع المشط للأسعار ولمديونية الدولة. فأصل الأزمة في تونس سياسي وألقى بظلاله على باقي مجالات الحياة بما فيها الوضعية الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي فإن المدخل الواقعي لحلّ الأزمة يبقى سياسيا وليس اقتصاديا كما يرى البعض. فقد تقلدت عديد الكفاءات في المجال الاقتصادي مناصب في الحكومات المتعاقبة لكنها لم تكن قادرة على الفعل، بالرغم من وجاهة بعض الإصلاحات المقترحة، لأن طبيعة الرهانات السياسية لا تسمح بذلك. والحديث هنا عن أولوية السياسي كمدخل وكإطار من أجل تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية وجودة الحياة. لكن، إذا كان هذا المنطق السياسي لتحليل الوضعية ينطبق على المرحلة الممتدة من أول انتخابات حرّة سنة 2011 إلى موفى جويلية 2021، فإنه من الصعب تحليل وضعية الانفراد السياسي لقيس سعيد بمختلف شؤون الحكم بنفس منطق المعقول السياسي الذي حكم العشرية التي سبقته. فنحن نفهم ما قامت به “النهضة” في إطار الإيديولوجيا السياسية للإسلام السياسي، كما نفهم تدبير النداء وما تفرّع منه في إطار عنوانه العام الفساد والانتهازية السياسية، لكن سياق المرحلة القيسية بتركيزها المفرط للحكم في يد شخص واحد وبديماغوجيا خطابية تكاد تتعارض مع أي منطق، تتطلب توسيع زاوية النظر وعدم الاقتصار على المنطق السياسي التقليدي.
ليس من باب المبالغة إذن الحديث عن نوع من التيه السياسي الجماعي بعد الثورة. وهو يعود في جزء منه إلى غياب الفهم العقلاني لطبيعة السياق البعد-ثوري (un contexte postrévolutionnaire) في علاقته بمسار تطور الدولة إضافة إلى غياب الرؤية على المدى المتوسط والبعيد. كما يعود في جزء آخر منه إلى الاختلاف حول الأسس التي تمثل إطار العيش المشترك في إطار التنوع السياسي. فنحن مختلفون حول الدولة واستقلالها، وحول طبيعتها وحتى حول شرعية وجودها (أمام تشكيك ثقافات ما قبل الدولة الإسلامية والعروبية). نحن مختلفون حول الديمقراطية وطبيعتها وجدواها حيث أصبحت الانتخابات مجرّد وسيلة لإكساء الشرعية على التوجه نحو السيطرة على الدولة واستعمال السلطة للصالح الخاص وليس للصالح العام منذ 2012. كيف التوفيق بين من يرى في الحرّية مطلبا شعبيا وبين من يرذّلها ويرى فيها التفافا على المسائل المعيشية؟ كيف التوفيق بين من يناضل من أجل الحرية وبين من يعتبرها حيلة غربية لتحطيم الدول؟ لقد وصلنا إلى حدّ الاختلاف حول جدوى الحرية، بعد انفراد قيس سعيد بالسلطة، مفضلين عليها الحاكم القوي وحتى التسلط السياسي والظلم. نحن مختلفون حول الثورة بين من يعتبرها كذلك وبين من يعتبرها انقلابا وحتى خيانة. كيف التوفيق بين من يرى في الثورة مؤامرة أمريكية وبين من يرى فيها هبَّة وطنية من أجل البناء المواطني والحقوقي؟ كيف التوفيق بين من يعتبر تونس مستقلة بجهد مناضليها وبُناتها ومن يشكّك في الاستقلال ويعتبر بورقيبة خائنا (سردية الإسلاميين والعروبيين)؟ كيف التوفيق بين من يرفض الديمقراطية بداعي أنها غربية مفروضة من أجل ضرب الاستقرار، وبين من يرى فيها مستقبل البلاد. قد تفسّر حدّة هذه الاختلافات، إلى حدّ ما، صعود من يمثل منطق القضاء على الاختلاف وتركيز حكم اللون الواحد باسم الشعب الواحد وراء قائده الأوحد.
من جهة أخرى، لا توجد سردية مشتركة لمختلف المكاسب التاريخية لتونس والتي من المفترض أن نَبنيَ عليها مستقبل البلاد. لذلك كان تطرّف الخطاب والاتجاه نحو القصووية بين الفاعلين السياسيين، سواء باسم التكفير أو باسم التخوين والعمالة، النتيجة الحتمية لهذا الخلاف حول الأساسيات التي تحكم العيش المشترك. إنه لمن المهمّ وضع تشخيص يأخذ بعين الاعتبار كل هذه المستويات بهدف ضمان الخروج برؤية أوضح تساعد على طرح بدائل ملائمة وتساهم في بناء أسس العيش المشترك بسردية جامعة لأغلب التونسيات والتونسيين. والأهم من ذلك، أنْ نضع حدا للانحراف نحو منظومة التسلط واستعادة وجاهة السياسة كوسيلة للتفكير وللتصرف في الشأن العام.
في هذا الإطار، أقدّم معطيين عاميْن من أجل محاولة فهم أعمق للأزمة وذلك قبل الدخول في تفاصيل الوضع في تونس منذ الثورة. أولا عدم التناسب بين الإمكانات الهائلة التي فتحتها الثورة كحدث تاريخي من جهة، ثم، من جهة ثانية، الإمكانات الفكرية للطبقة السياسية التي بقيت حبيسة الماضويات أو التحنط الإيديولوجي أو نضالية ما قبل الثورة. ثانيا، وهو الأهمّ، ذلك التعارض بين سياق التحول التاريخي ذي المضمون “التقدمي” بعد الثورة وبين تغلغل ثقافات ما قبل الدولة في المجتمع وعلى رأسها حركات الإسلام السياسي. حيث تمّ تحويل العملية السياسية من رهان إتمام البناء المواطني وعقلنة التصرف في الشأن العام إلى رهانات الحكم والتحكّم في الدولة بعقلية سلطانية أحيانا، أي بعقل الحَاكِميَّة[1].
[1] أستعمل مصطلح الحاكمية هنا في معناه الأصلي الذي ارتبط بالصراع في بدايات الإسلام حول الحكم وتحديد من يحكم، بين المنظور الشيعي، والسني والخوارجي
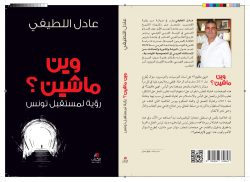
أستاذ عادل أنا عروبي ومؤمن أن مستقبل تونس والمشاكل التي تشهدها وكذلك المنطقة العربية لا يمكن أن تحل الا في إطار الوحدة العربية المنشودة وخاصة مع سعي مختلف الدول في اسيا وأفريقيا وأوروبا وامريكا إلى إقامة تكتلات اقتصادية تعمل على إيجاد تكامل اقتصادي واجتماعي . وأنت ممن يؤمنون أن بورقيبة قد تآمر مع الحكومة الفرنسية التي التجات اليه والى ملك المغرب لعقدت اتفاقيات ماسمي بالاستقلال بهدف ضرب الثورة الجزائرية والتآمر على الشق اليوسفي الذي تمسك بمبدأ أن استقلال تونس لابد أن يتم بالتواريخ مع استقلال الجزائر والمغرب ويمكن أن تعود إلىخطابات بورقيبة التي يقر فيها بدعوة منداي فرانس له عندما استعرت الثورة في الجزائر وقد وعد بورقيبة بوقف الكفاح المسلح وسحب أسلحة من يصفهم بالعلاقة وانت تفهم ماالذي توحي التسمية التي اطلقتها على الثوار ،وبالتالي فإني اعتبر أن استقلال تونس كان منقوصا والسيادة غير كاملة ( احتفاظ فرنسا بقاعدة في بنزرت وبقاء قواتها في الجنوب واحتفاظ المعمرين بممتلكاتهم حيث لم يتم الجلاء الزراعي الا سنة 1963)
مع التحية والتقدير واستكمال النقاش
سيدي الكريم، شكرا على المرور. لي كثير من التحفظات على ما ورد من تعليق. ما تقوله لا يقبله العقل المعرفي التاريخي وكل مؤرخي تونس بما فيهم من عارض بورؤقيبة متفقون حول موضوع الاستقلال. كان ذلك موضوع كتابي الأول سنة 2020. أنصحك أولا بمراجعة ما كتبه المؤرخون التونسيون. مثلا: بورقيبة نفسه لم يكم يعتقد في جدية فرنسا بعد 20 مارس 56، وكان يعرف أن السيادة غير مكتملة وقيل هذا في المجلس الوطني التأسيسي. بروتوكولات استقلال فرنسا تقريبا هي نفسها من تونس للسنغال لمدغشقر وحتى للجزائر.
الحياة السياسية لا يمكن أن تتم إلا في إطار دولة وطنية وليس في إطار أمة إثنية. لأن الرابط الإثني يعود بنا إلى ماقبل الدولة وما قبل الحداثة. مشكلنا أن الدولة الوطنية هشة.
hi