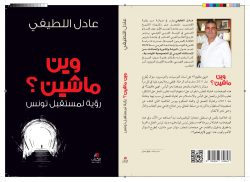- اعتبار الدولة الوطنية، أي الأمة السياسية، المبنية على الهوية الترابية المحدد بحدود ثابتة، تنظيما عقلانيا متعاليا على كل التشكيلات الاجتماعية السياسية المكونة له، وهي الفضاء الوحيد لوجود ولفعل كل المظاهر السياسية الحديثة من مواطنة وحريات وديمقراطية وعدالة اجتماعية وحقوق الإنسان. فتونس أمة سياسية، كباقي الأمم في العالم، تشكلت حول الانتماء لهوية ترابية مضبوطة في حدودها الثابتة الحالية بغض النظر عن الاعتبارات الدينية والثقافية والإثنية والعشائرية والجهوية. وعلى أساس هذا الانتماء تنبني المواطنة التونسية. إن الدولة هي الإطار الجامع لمختلف أشكال التنظيمات الأخرى ولها العلوية عليها (جماعات دينية، إثنية، عشائرية، أجسام مهنية…). كما تتوقف نجاعة هذه الدولة على مدى عقلانية تنظيمها في ارتباط وثيق مع حاجيات الأفراد باعتبارهم مواطنين متساوين. وتعتبر علمنة الدولة، أي فصل السياسة عن الدين، من بين مظاهر هذه العقلنة لما توفره من قدرة على التأقلم مع الأوضاع المادية الداخلية والخارجية (في إطار القانون الوضعي) وكذلك من حريات جماعية وفردية.
- كل ثقافات ما قبل الدولة الحديثة وعلى رأسها الإسلام السياسي تشكل تهديدا للدولة بالنظر لعدم تأقلمها الهيكلي مع عقلنتها وبالنظر إلى تشكلها التاريخي في رفض للدولة الوطنية. كما تدخل ضمن هذا الإطار تيارات القومية العربية التي تعتبر الدولة الوطنية مجرد مرحلة لبناء قومي أشمل يعتمد على العنصر الأثني. نضيف إلى ذلك ما يطرحه قيس سعيد سواء في الدستور أو في القانون الانتخابي مما يسمى “بالبناء القاعدي” الذي يعيد بناء الجهويات والعلاقات العشائرية بالإضافة إلى فصله للمواطنين عن السياسة وشأن الحكم.
- الإيمان بالحداثة باعتبارها عقلنة للوجود السياسي وللعلاقات الاجتماعية تهدف إلى النجاعة في تسيير الشأن العام في إطار العدالة الاجتماعية والحريات مع ما يستجوبه ذلك من مساواة تامة بين المواطنات والمواطنين ومن فصل للسياسة عن الدين. بهذا المعنى تُطرح الحداثة في بعدها الإنساني المشترك وليس باعتبارها نموذجا غربيا يفرض على الآخرين. فالحداثة تعني هنا تعميم العقلنة على مستوى التنظيم الدولتي (إدارة فعالة، مرجعية مدنية، تخطيط…) والمجتمعي (الحريات العامة والفردية والمساواة والعدالة الاجتماعية…)
- ليست الديمقراطية مجرد اختيار ضمن جملة من الاختيارات. فهي الإطار الوحيد الذي يضمن عمليا مشاركة فعلية للمواطنين في الحياة السياسية. والحديث هنا عن ديمقراطية واحدة هي نفسها التي تقتسمها أغلب أمم العالم، أي الديمقراطية التمثيلية. فهي في عمقها عقلنة للممارسة السياسية في مجتمع حر يتصرف في اختلافاته حول تسيير الشأن العام عبر تشريك كل قوى المجتمع السياسي. وتنبني الديمقراطية على الحريات، الجماعية منها والفردية، وعلى منظومة الحقوق، وعلى الأحزاب وقوى المجتمع المدني وحرية الإعلام والقضاء النزيه المستقل وانتخابات شفافة ونزيهة في إطار دولة قوية. بهذه الصيغة تكون الديمقراطية واحدة لا غربية لا شرقية، لا لبرالية ولا شعبية. ولا تقتصر الديمقراطية فقط على الانتخابات، بل تتواصل بعد ذلك عبر النقاش العمومي والحوار الاجتماعي ومختلف التعبيرات المجتمعية من عرائض واحتجاج في الفضاء العمومي وغيرها كي تشكل الديمقراطية الحيوية.
لكن للأسف بدأ بريق الديمقراطية يخفت بسبب الإخفاقات التي صاحبت التغيرات السياسية الأخيرة في العالم العربي وخاصة منها انتشار العنف والإرهاب. وقد التقت الأنظمة السلطوية في العالم العربي مع الخطابات الشعبوية، كما في تونس، للتشكيك في هذا المبدأ باعتباره “منتوجا غربيا لتدمير بلدان الجنوب”. ينبني هذا الادعاء على عقدتين أساسيتين تلازمان الفكر السياسي العربي منذ قرنين وهما، العجز على نقد الذات بما فيه نقد الموروث الثقافي، ثم حصر الآخر الغربي فقط في صورة العدو المتربص. فمن وجهة نظر تاريخية لا يعد مبدأ الديمقراطية غربيا وهو الذي نشأ خلال التاريخ القديم في أثينا وفي قرطاج المنتميتان لعالم الشرق وهو العالم الوحيد الذي كان موجودا آنذاك قبل روما.
كما تستبطن مقولة “الديمقراطية الغربية” وعيا عربيا وحتى غربيا بأن خصوصية الغرب الحضارية هي التي أفرزت الديمقراطية الحديثة، أي الديمقراطية التمثيلية. لكن مثل هذا القول يقفز على حقيقة تاريخية مهمة مفادها أن الشعوب في الغرب قد ناضلت من أجل الحصول على حق التمثيلية السياسية وعلى حق الانتخاب طوال قرون. فالغرب الحديث ولد دون ديمقراطية إلى حدود أواسط القرن التاسع عشر. نضيف إلى ذلك ما شهدته العديد من الدول من تراجع ديمقراطي مثل حال إيطاليا مع الفاشية وألمانيا مع النازية وإسبانيا مع الجنرال فرانكو. من جهة أخرى، إذا تتبعنا الشروط الموضوعية للديمقراطية التمثيلية، فسوف نجد أنها تخترق كل الثقافات. فهي تعتمد على حرية التعبير وعلى حرية التنظّم وعلى دور القوى الوسيطة والنخب بالإضافة إلى استقلال القضاء كسلطة مراقبة. ومثل هذه الشروط تتجاوز الخصوصيات المحلية. فلا وجود في الحقيقة لغرب أو شرق في هذا المجال، والخيار اليوم أمام الشعوب كما قلنا هو إما الحكم بالديمقراطية أو الحكم بالقوة.
- الإيمان بالحريات كمنظومة متكاملة في بعديها الجماعي والفردي. فهي الأصل لضمان الاستقرار الديمقراطي وللتحديث المجتمعي ولكل مظاهر الإبداع. وهي، المفتاح الذي يسمح بالتمتع بالحقوق. إن الحرية تعني أيضا تحرير الطاقات الإبداعية في مختلف المجالات من اقتصاد وثقافة وسياسة وفكر وغيرها. غير أن هذه الحريات الجماعية تبقى منقوصة دون حريات فردية تحرر الفرد من سطوة المجموعة خاصة فيما ارتبط منها بحقوق الإنسان. كما يتهدد الحرية خطر العودة إلى الخطاب السياسي “التحرري”. فمصطلح التحرر الوطني الذي يرفع مع قيس سعيد، هو مجرد وسيلة للتغطية على الفشل في تسيير الشأن العام وللالتفاف على الاستحقاق الديمقراطي بوضع المواطن في خيار خطير: إما الوطن أو الحرية.
- يتمثل دور الدولة، كجهاز وكسلطة، في ضمان الوسائل والسياقات المساعدة على إنتاج الثورة وعلى عدالة توزيعها عبر الحد من اللاعدالة (بين الفئات والجهات والأجيال) وفي ضمان الخدمات الأساسية وفي استشراف المستقبل وقيادة التحديث المجتمعي. فليس بالضرورة أن تكون الدولة فاعلا اقتصاديا ينافس المؤسسات الخاصة، بل القاعدة الأولى هي أن تكون للدولة مداخيل كافية من أجل ضمان الخدمات مثل الأمن والصحة والتعليم والماء والطاقة والبيئة السليمة… أن تأتي هذه المداخيل من عائدات الضرائب أو من أنشطة مربحة يقوم بها القطاع العمومي مباشرة فهي مسألة ثانوية. أما القاعدة الثانية فتتمثل في ضمان نجاعة أي من الأنشطة الاقتصادية ماليا واجتماعيا وكذلك بيئيا. فإن كانت المؤسسات الخاصة هي الأقدر على ذلك، تكتفي الدولة عندها بضمان دخل معقول من الضرائب حسب الربحية دون أن يكون ذلك عائقا للمؤسسة أمام التوسع وإعادة الاستثمار والوقوف أمام المنافسة. فنجاح الدولة يقاس بمدى قدرتها على تجنيد مقدَّرات المجموعة الوطنية وطاقاتها من أجل التقدم والرخاء الاقتصادي والاجتماعي.
ضمن هذه الرؤية يمكن أن نفهم معنى الدولة الاجتماعية. فهي ليست فقط الدولة المشغلة لأن طاقة الوظيفة العمومية محدودة. وهي ليست فقط الدولة التي توزع الأموال والمساعدات على الفئات الهشة بالرغم من أهمية مثل هذا التدخل. كما لا يمكن حصر دور الدولة الاجتماعي في توفير الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وأمن. فالدولة الاجتماعية تسهر على تقليص الفوارق وعلى مقاومة اللاعدالة بعد ضمان شروط إنتاج الثورة عبر الاستثمار والعمل، كما تشجع على الحوار الاجتماعي لضمان مناخ شغلي واستثماري سليم، وتوفر نفس شروط النجاح للأفراد بشكل متساوي. الدولة الاجتماعية هي التي تضمن الرقي الاجتماعي عبر التحديث المجتمعي، وتضمن أيضا موارد وبيئة أفضل للأجيال المقبلة. إنها الدولة التي تسهر على نجاعة التضامن الوطني وتُرسِّخ مبادئه، وتضمن جودة الحياة لأفرادها في إطار المساواة والعدالة.
- العدالة الاجتماعية التعاقدية بين الدولة (السياسات العمومية) والمواطن والتي تعني بالأساس العمل على الحد من اللاعدالة كما سبق وأشرت في التقديم النظري للقسم الثاني. حيث توفر الدولة الشروط والوسائل الضرورية للمواطن في كل أنحاء البلاد كي يتمكن من التنمية الاجتماعية الذاتية بكل حرية ضمن ثنائية الحقوق والواجبات واعتبار الذات. فالسبب الأساسي للفوارق الاجتماعية ليس فرديا بنجاح هذا وفشل ذاك. بل يعد اختلال حظوظ الأفراد للتمتع بخدمات الدولة منذ البداية، عاملا حاسما في إعادة إنتاج الفوارق سواء بين الأفراد أو المجموعات أو الجهات. فأرقام النجاح في الباكالوريا مثلا ناطقة بذاتها وليس من الغريب أن نجد ولاية مثل القصرين في آخر القائمة. من هنا تأتي أهمية العمل على توفير نفس شروط النجاح كي يتمكن الفرد من الاندماج في إطار هذه العدالة الاجتماعية التعاقدية، أي في النهاية ضمان القدرات المتساوية. وبحكم الارتباط الوثيق بين العدالة الاجتماعية والاقتصاد في عالم مفتوح تحكمه العولمة، فإن العمل على تحقيقها يكتسي أيضا طابعا دوليا. من هنا يأتي أحد أدوار السياسة الخارجية للدولة، أي الدفع باتجاه سياسة دولية اجتماعية.
- التصرف العقلاني في موارد المجموعة الوطنية باعتماد التخطيط لسياسات عمومية ناجعة هدفها المواطن الإنسان وذلك بالاشتراك مع المؤسسات الخاصة ومع قطاع الاقتصاد التضامني. ويعني ذلك وجود رؤية على المدى البعيد والمتوسط والقريب تتم ترجمتها على أرض الواقع من خلال تخطيط واقعي يأخذ بعين الاعتبار مختلف الإكراهات الداخلية والخارجية.
- يتم إنتاج الثروة في إطار تكامل بين السياسات العمومية والاستثمار والعمل بما يخلق توازنا بين حاجيات الدولة، وربحية المؤسسات، والتنمية الاجتماعية، والبيئية. ويتطلب هذا التكامل تواصلا بين مختلف الأطراف الفاعلة من سلطة تنفيذية وممثلي المؤسسات الاقتصادية والنقابات والمجتمع المدني. إن خلق الثروة وتواصلها يبقى رهين مدى التكامل بين مختلف هذه العناصر مما يطرح الدور الحيوي للحوار الاجتماعي.
- اعتبار الاقتصاد البيئي، أو الأخضر، الذي يراعي حماية المحيط شرطا أساسيا لبناء التنمية المستدامة والتقدم. فإنتاج الثورة وحل الإشكالات الاجتماعية، مثل البطالة أو التنمية الجهوية، لا يجب أن يكون على حساب بيئة سليمة تحافظ على الصحة العمومية وعلى حق الأجيال المقبلة. وتتزايد أهمية هذا المعطى باعتبار التوجه العالمي نحو الحفاظ على البيئة السليمة كما أنه يستجيب لحاجة وطنية ملحة ونحن نعاني في تونس من تبعات التغير المناخي وتزايد خطر التصحر.
- الثقافة العقلانية الضامنة لتحصين الشباب وبناء الأجيال المقبلة على قاعدة الانفتاح والإبداع. حيث تلعب المدارس والجامعات العمومية وكذلك النخب دورا رياديا في هذا التوجه من خلال تجاوز الماضويات عبر الفكر النقدي البناء الذي يستلهم من العلوم الاجتماعية والسياسية. إن انحصار فضاء فعل الثقافة العقلانية هو من بين أسباب تخلف العالم العربي وبقاء المجتمع رهين المحافظة وعودة ثقافات ما قبل الدولة في المجال السياسي.
- الإيمان بالبعد الإنساني (humanisme) باعتباره ركنا أساسيا من أركان الحداثة وأساسا للتواصل بين الشعوب والثقافات. إن تعميق هذا المبدأ في ثقافتنا يساهم في تحصين الرأي العام أمام الثقافات العنصرية والشعبويات ومختلف الماضويات. كما يساهم هذا المنزع الإنساني في الخروج من العلاقة المتوترة مع الآخر والاستفادة من التجربة الإنسانية بعيدا عن عقدة النقص وعن عقلية المؤامرة.